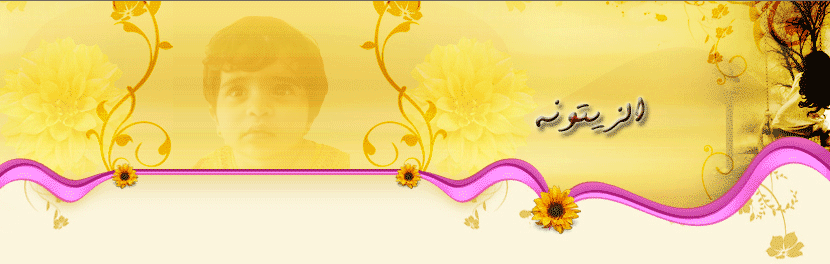بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
لقد رأيت بعض المسلمين يخطأ في تعامله مع النصارى وغيرهم و قد نسوا أنهم من أهل الكتاب, و كنت في حيرة من أمري كيف لي أن أتعامل مع غير المسلمين. هل هي معاملتهم بالحسنى أم العكس! و قد غفلت عن سماحة الإسلام و أنه حثنا بما هو طيب و ما هو في قمت الأخلاق. و من قراءتي لمواضيع كثيرة متعلق في الموضوع وجدت أن الإسلام بتعاليمه يريدنا مثل الماس الخالص و أنقى, أعني من تعبيري أن الإسلام حثنا على المعاملة الطيبة أياً كان من تعامله. حتى مع من أساء إليك. فكاظم الغيض له أجره, و المسامح له أجره, و من جازى الإساءة بالحسنى له أجره. و لكن لن أضيف تعليقي و سأترككم لبعض ما قرأت حول الموضوع
كيف يرى الإسلامُ المسيحيَّة؟
"لعلَّ أحداً لم يُحسِن التعبير عن غاية رسالة الإسلام مثلما عبَّر عن هذه الغاية الصحابيُّ "ربعيُّ بن عامر" عندما دخل على رستم؛ فسأله: من الذي ابتعثكم؟ فرد قائلا: "إن الله ابتعثنا لنُخرِج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام".
واللافت للنظر أن ربعيًّا ذلك الصحابيَّ الآتي من الصحراء قد أدرك أن جوهر رسالة الإسلام في أنها رسالة تحريرٍ للإنسان، تحرِّره من عبوديته للبشر لتكون عبودية الجميع لربِّ البشر، وأنها رسالة عدلٍ جاءت لتقضي على مظاهر الظلم في الكون كله.
وإذا كانت رسالة الإسلام جوهرها العدل والحرية؛ فإنها لا بد أن تحترم الإنسان، سواء لعقيدته أو لإرادته؛ ولذلك كان الأمر الإلهيُّ واضحاً منذ بداية تكليف النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "فذكِّر إنَّما أنت مذكِّر، لست عليهم بمصيطر".
وإذا كان احترام الإسلام لحرية الإنسان في اختياره العَقَديِّ ثابتاً لا مراء فيه حيث "لا إكراه في الدين"، "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"؛ فإن احترام الإسلام للعقائد السابقة عليه يأتي متَّسقا مع جوهر رسالته وصريح نصوصه.
وقد ذكَّر الوحي القرآنيُّ النبيَّ الكريم بأنه ختامٌ لسلسلةٍ سبقته من الأنبياء والمرسلين، كلُّهم حمل نفس دعوة التوحيد، وأمر الناس بالرجوع لخالقهم، ورفض طغيان العباد: "ولقد بعثنا في كل أمَّةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت".
وأمره بأن يحتمل ما أصابه من أذى؛ لأن ذلك كان سبيل إخوانه من الرسل: "فاصبِرْ كما صبر أولو العزم من الرسل"، كما ذكَّره سبحانه فقال: "نزَّل عليك الكتاب بالحقِّ مصدِّقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبلُ هدىً للناس وأنزل الفرقان".
وذكر القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه يؤمنون بجميع الرسل بلا تفرقة: "آمن الرسول بما أُنزِل إليه من ربِّه والمؤمنون كلٌّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرِّق بين أحدٍ من رسله…".
وهكذا نجد أن الإسلام لم يعترف فحسب بما سبقه من رسالاتٍ سماوية، بل إنه أمر المسلمين بأن يؤمنوا بجميع الرسل وجميع الكتب التي أُنزِلت كما أنزلها الله سبحانه وتعالى.
وقد فرَّق الإسلام منذ بدايات الدعوة في القرآن المكيِّ بين الكفَّار من عبدة الأوثان أو غيرهم وبين اليهود والنَّصارى الذين سماهم "أهل الكتاب" اعترافاً منه بأنهم حملة كتابٍ سماويّ، وإن كان لم يبق على نفس الصورة التي نزل بها من عند الله، إلا أن أتباعه ليسوا كغيرهم؛ إذ يؤمنون بكتابٍ وبرسول، ولهم دينهم ودياناتهم التي جاء الإسلام متمِّماً لها: "وأنزلنا إليك الكتاب بالحقِّ مصدِّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه". (المائدة: 48).
وقد أمر الله المسلمين في سورة مكيةٍ وهي سورة العنكبوت بأن يجادلوا أهل الكتاب في الأمور التي يختلفون معهم فيها عقائديًّا مجادلةً حسنة: "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم".
وعندما قدم النبيُّ الكريم صلي الله عليه وسلم المدينة، وقامت دولة الإسلام ككيانٍ سياسيٍّ واضح، نصَّت الصحيفة التي تُعتَبر دستور الدولة على نصوصٍ واضحةٍ في الاعتراف بحقِّ يهود المدينة في أن يكونوا مواطنين في هذه الدولة، مع احترامٍ كاملٍ لعقيدتهم؛ وممَّا ورد في هذه الصحيفة نصٌّ يقول: "وإنَّه من تبعنا من يهودٍ فإنَّ له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصَر عليهم… وإنَّ يهود بني عوف أمَّةٌ مع المؤمنين: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم؛ فإنه لا يوتِغ (أي يُهِلك) إلا نفسه وأهل بيته، وإنَّ ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف…"، وعدد طوائف اليهود بالمدينة.
ثم نصت على أن الجميع ملزمٌ ببنود هذا الدستور: "وإنَّ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإنَّ بينهم النَّصر على من حارب هذه الصحيفة، وإنَّ بينهم النُّصح والنَّصيحة والبرّ دون الإثم".. (انظر نص الصحيفة كاملاً في سيرة ابن هشام - الجزء الثاني).
هكذا كان تعامل الإسلام، سواء في مرحلة الاستضعاف بمكة، أو عندما أصبح له دولةٌ وكيانٌ سياسيٌّ مستقلّ، وإذا كان تعامل الإسلام مع أهل الكتاب عامَّةً بهذا المنهج؛ فإنه مع النصارى كان له وضعه المتميِّز؛ ففي المرحلة المكيَّة نجد أن المسلمين أصابهم الحزن والغمُّ عندما انتصر الفرس (وهم عبدة النار) على الروم (وهم نصارى أهل كتاب)، وأُنزل في ذلك قرآنٌ يُتلَى إلى يوم الدين يبشِّر المسلمين في مكَّة بأن الروم -وهم الأقرب إليهم- ستكون لهم الغلبة، قال تعالى: "الم، غُلِبَت الرّوم، في أدنى الأرض وهم من بعد غَلَبِهم سيَغلِبون، في بضع سنينَ لله الأمر من قبلُ ومن بعدُ ويومئذٍ يفرح المؤمنون، بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم".
هكذا يذْكر القرآن أن المسلمين سيفرحون يوم تكون الغلبة للروم (النصارى) على الفرس (عبدة النار).
وعندما اشتد اضطهاد أهل مكة وتعذيبهم للمسلمين نَصَحَهم النبيُّ الكريم بأن يلجئوا إلى الحبشة النصرانية، لأن بها ملِكاً عادلا، لا يُظلَم عنده أحد، بتعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهاجر نفرٌ من المسلمين إلى الحبشة وعاشوا فيها سنين عددا؛ حتى استقرت دولة الإسلام بالمدينة، وقد أحسن النجاشيُّ وِفادتهم، ورفض تسليمهم لقريش عندما أرسلت رسولها يطلب ذلك.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل -ضمن رسائله إلى العديد من الملوك والحكام- رسالةً إلى هرقل قيصر الروم، كما أرسل إلى المُقَوقَس حاكم مصر من قِبَل الرومان، وكان استقبال كلٍّ من الرجلين طيِّبا، لا سيَّما المُقَوقَس الذي أرسل إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هدايا تدلُّ على مدى تقديره له.
هكذا كانت بدايات العلاقة بين الإسلام والمسيحية، وهي كما نرى تدلُّ على أنَّ هذه العلاقة سيسودها الودُّ والوئام، وهكذا كان موقف المسلمين الذي قرءوا في قرآنهم: "لتجدنَّ أشد الناس عداوةً للذين آمنوا اليهودَ والذين أشركوا ولتجدنَّ أقربهم مودَّةً للذين آمنوا الذين قالوا إنَّا نصارى ذلك بأنَّ منهم قسِّيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون".
أما عن الخلافات العقائدية بين عقيدة المسلمين وبين ما يعتقده النصارى من تأليهٍ لعيسى عليه السلام؛ فإن الإسلام –مع استنكاره لذلك- يناقش مناقشةً منطقيَّةً حرَّةً تاركًا لكلٍّ أن يختار ما يشاء من عقيدة.
وقد قَدِم على الرسول الكريم وفدُ نجران من النصارى، فجادلهم كما علَّمه القرآن: "قل يا أهل الكتاب تعالَوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذَ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإنْ تولَوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون"، وتناول القرآن مسألة ألوهيَّة عيسى عليه السلام تناولاً عقلانيّا: "ما المسيح ابن مريم إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل وأُمُّهُ صِدِّيقةٌ كانا يأكلان الطعام…"، ففي الآية تكريمٌ وتعظيمٌ للمسيح وأُمِّه التي طالما ذكرها القرآن بكل الفضل والاصطفاء، وفي الآية أيضاً ردٌّ منطقيٌّ على القول بألوهية عيسى وأمه؛ لأنهما يتَّصفان بما يتَّصف به البشر من أكل الطعام وما يستلزمه، وذلك ما ينبغي أن يتنزَّه عنه الله سبحانه وتعالى؛ لأنه صفة نقص لا صفة كمال، ولكنَّ ذلك لم يكن داعياً لعداوةٍ مستحكمةٍ بين المسلمين والنصارى؛ إذ يُقِرُّ الإسلام بحقِّ الآخرين في اعتقاد ما يشاءون، ولا أدلَّ على ذلك من الاحترام الشديد الذي لاقاه نصارى البلاد التي فتحها المسلمون لعقائدهم وكنائسهم وصلبانهم، وقد ظلَّ من شاء من أهل هذه البلاد متمسِّكاً بعقيدته؛ فما تعرَّض لهم أحدٌ وما أحسُّوا غُبْناً ولا ظلماً تحت راية الإسلام وحكمه.
إنَّ نظرةً فيها أدنى إنصافٍ لتعامل المسلمين مع المسيحيِّين في البلاد التي فتحوها، ولِمَا فعله المسيحيُّون من خلال حملاتهم الصليبيَّة، وخلال المأساة التي يندى لها جبين البشرية عند هزيمة المسلمين في الأندلس، لتدلُّ على أن المسلمين كانوا دوماً أهل عدلٍ وإنصاف، وأن المسيحيِّين في هذه العصور ما تعاملوا فقط بشيءٍ من العدالة واحترام الآخرين عقديًّا وفكريّا.
ولكنَّنا لا نبغي بذلك أن نثير أحقادا، وإنِّما نذكِّر –فحسب- بموقف الإسلام على المستوى النظريِّ وعلى المستوى العمليِّ على حدٍّ سواء، وإذا كان أهل الكتاب لا يقرُّون بنبوَّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ولا بكون القرآن وحياً إلهيًّا؛ فإنَّ المسلمين يجعلون موسى وعيسى عليهما السلام في الذُّروة من السلسلة المطهَّرة التي اصطفاها الله، وهم أولو العزم من الرسل، والمسلمون يؤمنون بما أُنزِل عليهم من كتبٍ مردِّدين قول ربهم عز وجل: "وقولوا آمنَّا بالذي أُنزِل إلينا وأُنزِل إليكم وإلهُنا وإلهُكم واحدٌ ونحن له مسلمون".
وبالجملة؛ فالمسلم في موقفه من المسيحيِّ ينطلق من عدَّة اعتبارات:
أولها: أنَّه ينزله حيث أمر الله من كونه من أهل الكتاب الذين أُمِرنا بأن نجادلهم نظريًّا بالتي هي أحسن.
ثانيها: أنَّه من الناحية العمليَّة، يُتعامَل معه بقيم الإسلام التي تقوم على العدالة والمساواة والحريَّة والإحسان إلى الآخر.
ثالثها: أنَّ المسلم -وإنْ كان مأموراً بدعوة الآخرين إلى عقيدة التوحيد التي يعتقدها- فإنَّه يمارس هذا الدور في حدود الآداب التي تعلَّمها من دينه؛ تاركاً لكلِّ إنسانٍ أن يختار عقيدته.
رابعها: أنَّه يرحِّب بكلِّ تعاونٍ على الخير، وعلى البرِّ والتقوى، وعلى إشاعة قِيَم الفضيلة والعدالة والطهارة في المجتمعات، بدلاً من عبادة اللذَّة والانكفاء على الذات واستنزاف حقوق الشعوب المستضعفة والإباحية الجنسيَّة التي توشك أن تُهلك المجتمعات.
المصدر: IslamOnline.Net
هذا هو نشاط درس حرية الاعتقاد في الإسلام
أتمنى أن ينال إعجابكم